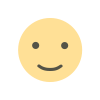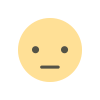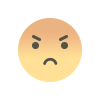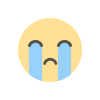ألبير كامو: عندما يكون التمرد ضد الوجود طريق النجاة
مقال يستعرض فلسفة ألبير كامو حول عبثية الوجود وتمرده الفكري في كتاب "أسطورة سيزيف"، حيث يتحول التمرّد إلى خلاص، وتغدو مواجهة العبث طريقًا نحو حياة أصيلة لا تستسلم للوهم أو اليأس.

بين الفينة والأخرى، تعترينا هاجسة تُلقي بظلّها الثقيل على سويداء القلب مفادُها هل الحياة عبثٌ لا طائل من ورائه؟ وهل سعينا فيها ضربٌ من اللهو العقيم؟
يرى ألبير كامو، الفيلسوف الذي نفذ ببصيرته إلى أعماق هذا الشعور، أنّ الإنكار الواهم لعبثيّة الحياة لا يُسمن ولا يُغني من جوع، بل هو من قبيل الخداع النفسي، يُروّج لطمأنينة زائفة. وإنّما السبيل إلى سعادةٍ صادقة، أن نواجه هذا المصير الساخر مواجهة الندّ للندّ، ونزدريه ازدراء من أيقن عبثه، دون أن ينكسر له أو يخضع.
فالإنسان كائن متقلّب الطباع، متباين الأحوال. تارةً تفيض روحه بنشوة الحياة، ويخال أن لخطاه معنى، وأن لوجوده غاية؛ وتارةً أخرى، يتبدّد ذلك الشعور فجأة، فيبدو له الوجود برمّته خواءً لا يسكنه معنى، وعبثًا لا تتوّجه غاية. فإن سلّمنا بأنّ ما نصنعه لا يزن شيئًا في ميزان الكون، فهل نُذعن للعدم، أم نُعانق الحياة رغم عبثها، ونقف منها موقف الساخر المتحدّي؟
لقد استهوت هذه المفارقة كيان الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو (1913 – 1960)، فاختارها ميدانًا لتأملاته، ومنطلقًا لسبر أغوار المعنى واللاجدوى. وفي كتابه الشهير أسطورة سيزيف (1942)، دوّن أفكاره حول هذا المأزق الوجودي، مستهلًّا بقوله:
«ليس ثمة سوى مسألة فلسفية واحدة تستحق النظر، ألا وهي الانتحار. فالحكم على ما إذا كانت الحياة تستحق أن تُعاش، إنما هو جواب على السؤال الفلسفي الأول والأهم.»
فهل تستحق الحياة أن تُحيا؟
وللبدء في معالجة هذا السؤال الجذري، استحضر كامو مشاهد الرتابة اليومية، كاشفًا عن العبث الكامن في صُلب المألوف، فقال:
«الاستيقاظ، الترام، أربع ساعات من العمل في المكتب أو المصنع، وجبة، الترام، أربع ساعات أخرى من العمل، وجبة، نوم... والاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، والسبت، وفق الإيقاع ذاته — هذا المسار يُسلك بلا عناء في أكثر الأحيان. ولكن، في يومٍ ما، ينبثق السؤال: لِمَ؟... وعندئذٍ يبدأ كلّ شيء، في ذلك الإعياء المشوب بالذهول.»
ألبير كامو وتمرد الوعي على فراغ الوجود
يُشبِّه كامو حال الإنسان المعاصر بحال سيزيف، بطل الأسطورة الإغريقية القديمة، الذي أغضب الآلهة فأنزلوا به عقوبةً فريدة في عبثها: أن يدفع صخرةً عظيمة إلى قمة جبل، فما إن يُوشك أن يبلغها، حتى تتدحرج الصخرة من عليائها إلى السفح، فينزل سيزيف ليعيد الكرّة من جديد. وهكذا دواليك، في دائرة لا تنتهي، وجهاد لا يورث راحةً ولا جزاء.
يكتب كامو في هذا الصدد:
«عامل اليوم، يؤدي كلّ يوم مهامّه ذاتها، وهذا المصير ليس بأقل عبثية من مصير سيزيف.»
غير أن وجه الشبه بيننا وبين سيزيف، في نظر كامو، لا يقف عند حدود التكرار والروتين وحدهما، بل يتجاوز ذلك إلى الفراغ الكامن في جوهر الفعل الإنساني حين يُجَرَّد من المعنى.
فالعبث عند كامو ليس مجرّد رتابة الأيام وتعاقب المهامّ، بل هو صراع بين توق الإنسان إلى المعنى من غربة الوجود. يكتب قائلا:
«لا أدري إن كان لهذا العالم معنًى يجاوز حدوده وينأى عنه. غير أنّ الذي أعلمه، علمَ اليقين، أنّني أجهل ذلك المعنى، وأنّ إدراكه، في راهن ساعتي، متعذّرٌ عليّ. فأيّ معنًى يمكن أن يكون لذاك الذي يقع خارج شرط وجودي؟ إنّي لا أفقه إلا ما جاء على مقاس الإنسان. ما ألمسه، ما يصدّني ويقاومني — هو وحده ما أدركه. وأنا بين رغبتين متعارضتين: توقٍ إلى المطلق والوَحدة، من جهة، وعجزٍ عن إخضاع هذا العالم لمبدأٍ عقليٍّ منتظم، من جهة أخرى — أعلم أنّني لا أستطيع الجمع بينهما ولا التوفيق.»
نحن نقيم، على حدّ تعبير كامو، في فسحة عبثيّة يتنازعها أمران متقابلان: نزوعنا الفطري إلى طرح الأسئلة الكبرى، وعجزنا الوجودي عن الظفر بإجابات تشفي الغليل وتسدّ الخلل.
يقول كامو:
«يقف الإنسان وجهًا لوجه أمام اللامعقول. يشعر في أعماقه بتوقٍ إلى السعادة، وإلى النظام العقلي. والعبث يولد من هذا التلاقي بين الحاجة الإنسانيّة، وصمت العالم غير المعقول.»
هنا تتجلّى مأساة الوعي البشريّ، لا في جهله، بل في شعوره العميق بهذا الجهل، وفي توقه الذي لا يَخمد إلى المعنى، مقابل كونٍ لا يجيب، وصمتٍ لا يُفسَّر. فالعبث، في جوهره، ليس خاصيّة في العالم وحده، ولا في الإنسان وحده، بل هو وليد الاصطدام بين هذا وذاك، بين الرغبة الملحّة في فهم جوهر الوجود.
ومن هنا تتجلى صورة سيزيف في أبهى تجلياتها الرمزية: نبني أُطرًا تُضفي على الحياة معنًى، ونُشيِّد مشروعات نُراهن بها على الوجود، فإذا بها تنهار تحت وطأة الزمن أو العبث أو الخيبة، فنعود إلى البدء، مدفوعين بدافعٍ قَهري، لنُعيد الكرّة من جديد.
يريد كامو أن نعي حقيقةً جليّة وإن كانت موجعة: ما دامت غاية الكون، في جوهرها، مستغلقة علينا؛ وما دام صمت الوجود غير معقول في وجه أسئلتنا؛ فإن كلّ اختيار نختاره، وكل منظومة قيَم نعتنقها، ليست إلا ضربًا من الاعتباط.
فإن أقبلنا على عقيدةٍ بعينها إقبال التسليم، وأوهمنا أنفسنا بأنّ ما نؤمن به هو الحقيقة المجرّدة، فقد نغنم شيئًا من العزاء، غير أننا نكون — في نظر كامو — قد اقترفنا ضربًا من الانتحار الميتافيزيقي.
وهكذا، وفي سعينا إلى حياة غير مزيفة، نقع — بلا وعي — في براثن الزيف، ونؤثر الخَدَر على المواجهة.
حين يُصبح التمرّد ضد الوجود خلاصًا
يرى كامو أن السبيل إلى حياةٍ غير مزيفة ليس بالفرار من عبث الحياة أو إنكاره، بل بالتأمّل في الكيفيّة التي يمكننا أن نحيا بها رغم العبث. وفي مراجعة كتبها عام 1938 لرواية الغثيان لسارتر، يقول كامو:
«إن إدراك أنّ الحياة عبثٌ لا ينبغي أن يكون نهاية المطاف، بل البداية. وهذه حقيقة اتخذها معظم العقول الكبرى منطلقًا. فليس في هذا الاكتشاف ما يثير الاهتمام، وإنما في النتائج العملية والقواعد السلوكية التي تُستقى منه.»
ليست هذه القواعد التي يستنبطها كامو دعوة إلى استسلام أو هروب، بل إلى ثورة ميتافيزيقية: رفضٌ قاطع للرضوخ للعبث، لا عبر الوهم، ولا عبر اليأس، لا بالانتحار الخقيقي، ولا بذلك الانتحار الميتافيزيقي الذي يتمثّل في دفن الوعي تحت ركام الطمأنينة الزائفة.
وفي أسطورة سيزيف، يصف كامو هذا التمرد بأنه:
«مواجهة دائمة بين الإنسان وغموضه الخاص… مواجهةٌ تتحدّى العالم في كل لحظة. وكما أن الخطر منح الإنسان فرصةً فريدة للوعي بذاته، فإن الثورة الميتافيزيقية توسّع هذا الوعي ليشمل مجمل التجربة الوجودية.»
وبهذا، فإن رفض الأوهام المريحة لا يُعدّ خسارة، بل انفتاحًا صادقًا على الحياة كما هي: في آنها الحاضر، وفي حقيقتها الجليّة، بلا تزويق.
وكما قال كامو:
«لا شمس بلا ظل، ومن الضروري أن نعرف الليل.»
سيزيف الساخر: مأساة بلا يأس وتمرّد بلا أمل
لإيصال فكرته إلى منتهاها، يدعونا كامو إلى أن نُعيد النظر في سيزيف، لا بوصفه ضحيةً تُستدرّ لها الشفقة، بل بطلاً يستحق الإعجاب. فعلى الرغم من كل شيء، يخبرنا كامو أن سيزيف يمضي قُدمًا. إنه يُجسِّد تلك الحقيقة التي نميل إلى إنكارها: أن في مقدورنا أن نحيا، ونحن نعي تمامًا هشاشة مصيرنا، من غير أن نستسلم له أو ننكسر تحت وطأته.
فحين تتدحرج الصخرة من جديد — مؤكّدة عبثيّة الوجود برمّته — لا يتردّد سيزيف، بل ينزل الجبل ليلحق بها، ويُعيد المحاولة.
في هذه اللحظة تحديدًا، يرى كامو أن عبثية المصير تنكشف على نحوٍ تام، وفيها يبلغ سيزيف وعيه التراجيدي الكامل. وهو ينحدر في طريقه نحو السفح، يعلم علم اليقين حقيقة شقائه، ومع ذلك، فكل فرحه الصامت كامِنٌ في هذه اللحظة. فمصيره بات له، والصخرة صارت "شأنه الخاص".
وهكذا يعيد كامو تأويل مأساة سيزيف لا باعتبارها عقوبة كئيبة، بل فرصة لصياغة معنى ذاتي، وموقف وجودي. لم يعُد ينظر إلى صخرته بعين القنوط، بل اختار — عن وعي — أن يسير وراءها، مستعيدًا زمام الرواية، ساخرًا من الآلهة، ومتمرّدًا على عبث العقاب.
وما سيزيف سوى صورتنا، نحن البشر. كل أزمة معنى نمرّ بها، كل مشروع ينتهي، كل جهد يعود إلى نقطة البدء — نحن سيزيف في طريقه نحو السفح. والسؤال هو:
هل نرثي لحالنا؟ أم نختار التمرّد، كما تخيّله كامو، ونقف في وجه المصير؟
يقول كامو:
«ما من مصير لا يمكن التغلب عليه بالازدراء.»
إن مقاربتنا للحياة بوعيٍ كامل، وبحيويةٍ صادقة، وبتمرّدٍ لا يطلب عزاء، هو السبيل إلى دحر العدمية، وتشييد معنى جديد للوجود، لا يُستمد من خارجه، بل يُنتزع منه.
فمع أنّ كامو يرى أن العبث قدرٌ لا فكاك منه، إلا أنه لا يراه سببًا لليأس، بل منطلقًا للحياة الحقّة. إذ ليست الأصالة في أن نجد معنًى جاهزًا، بل في أن نواصل السير رغم غيابه، وننهض كلّما هوَت الصخرة من جديد.
قد لا تمنحنا مشاريعنا الحياتية الرضا الكامل، وقد نفقد الثقة في القيم التي نعتنقها، وقد يلازمنا الإحساس بأن الوجود يخلو من المعنى النهائي؛ ومع ذلك، ما دمنا نواصل المسير، ونرفع رؤوسنا دون انحناء، فربما نجد الفرح — ذلك الفرح العصِيّ، العنيد، الصادق — في مجرّد الكفاح.
فكما يختم كامو أسطورة سيزيف:
«الصخرة ما تزال تتدحرج. أترك سيزيف عند سفح الجبل! فكل امرئٍ يعثر على عبئه من جديد. غير أن سيزيف يُعلّمنا الوفاء الأعلى، ذاك الذي ينكر الآلهة ويرفع الصخور. هو أيضًا يصل إلى خلاصة مفادها أن "كل شيء على ما يُرام". فهذا الكون، وقد خلا من سيّد، لا يبدو له عقيمًا ولا تافهًا. كل ذرّةٍ من تلك الصخرة، كلّ شُعاعٍ من ذلك الجبل المظلم، يشكّل في ذاته عالَمًا. والكفاح في سبيل القمّة، في ذاته، كفيلٌ بأن يملأ قلب الإنسان.»
وبالنهاية، ينبغي أن نتخيّل مدى سعادة سيزيف لأنه إنعكاس لطبيعتنا البشرية.